عوالم الحداثة.. بين الإطلاق.. ومنظومة التجارب..!
د. رفيق عبد السلام*
ينزع الكثير من المثقفين والسياسيين العرب إلى أدلجة الحداثة وتقديمها في صورة نمطية مكتملة لا تقبل المساءلة أو التدارك، وكأن هذه الحداثة قوة غيبية معزولة عن حركة التاريخ الحي وخبرة البشر، وقد غدا أمرا مألوفا في عالمنا العربي استخدام كلمة حداثة وبعض ملازماتها من المفاهيم الأخرى مثل التحديث والعقلنة والتقدم بصورة ملتبسة إلى جانب استدعاء هذه المفاهيم في معارك سياسية وايديولوجية قاصرة، من ذلك ما نشهده من محاولات دائبة لتصوير ما يجري في الساحة الثقافية والسياسية العربية من استقطاب وتوترات على أنه معركة بين معسكر الحداثة والحداثيين ومعسكر المعادين للحداثة والعصر، كما غدا أمرا مألوفا أن تتوارى أكثر الأنظمة استبدادية وتسلطا على رقاب مواطنيها بادعاءات حداثوية وتنويرية، بعد أن قام بعض المثقفين «التنويريين» وبعض اليساريين المتقاعدين بخدمة جليلة لنخب الحكم العسكرية في المنطقة من خلال «تعميدها» بالمدونة الحداثية السياسية.
كان من الممكن للمرء أن يثني على حماسة مثقفينا في الدفاع عن الحداثة والتجديد والابداع لو كان لهم فعلا نصيب يذكر من الابداع أو المساهمة الجادة في الحداثة ـ خطابا وكسبا تاريخيا ـ أما أن يقتصر دور غالبيتهم العظمى على ترديد مشوه واختزالي لما يتلقونه من الضفة الأخرى من العالم، وفي الكثير من الأحيان عبر تراجم قلقة وملتبسة فهذا ما يدعونا إلى الشك في صدقية ادعاءاتهم الابداعية والحداثية، هذا الأمر أشبه ما يكون بتلك الحماسة الزائدة التي تأخذ بعض المثقفين والكتاب العرب وهم يتحدثون عن فضائل العولمة والقرية الكونية الموحدة وكأنهم شركاء فعلا في نحت معالم هذه العولمة أو في صنع هذه القرية الكونية، وليسوا مجرد مستهلك سلبي يقبع في العربة الخلفية لحركة العولمة.
ليس عيبا أن يكون المرء مستهلكا ومتلقيا عن غيره، فكل الأمم الحية تعلمت من غيرها وأخذت ما يساعدها على امتلاك ناصية النهوض، ولكن العيب كل العيب أن تضاف قلة الفطنة وغياب الوعي والبصيرة إلى قلة العمل الابداعي والاجتهادي، فيغلف القعود الفكري بالنقد، ويلبس جمود التقليد بادعاءات الابداع والتجديد، والغريب في الأمر أن هؤلاء المثقفين على كثرة ما يثيرونه من ثرثرة حول الإبداع والنقد إلا أننا لم نر لهم أثرا يذكر في حركة الابداع إذ يغلب على أعمال غالبيتهم العظمى طابع الاجترار والتقليد الرتيب والميت.
هذا المسعى إلى «عولمة الحداثة» ليس حالة قاصرة على المثقفين العرب بل يتعداهم إلى الكثير من المفكرين الغربيين الذين يميلون إلى تصعيد النموذج الحداثي الأنواري إلى مستوى الكونية الجامعة، فالفيلسوف الألماني يورغن هابرماز مثلا والذي يعد واحدا من أهم من كتبوا في هذا الحقل منذ مطلع الخمسينات، ينتهي إلى بناء نموذج نظري للحداثة لا يخرج عن نطاق الإرث الأنواري الغربي الذي هو عند التمحيص الدقيق ليس إلا إرثا مسيحيا معلمنا، ورغم تأكيد هابرماس في مواضع مختلفة من أعماله على أن الحداثة هي انفتاح على امكانيات متعددة إلا أنه ينتهي إلى حصر دائرة الإمكان في النموذج الليبرالي الأنواري ذي المختزنات المسيحية اليهودية، ورغم نقده الشديد للادعاءات الشمولية للآباء المؤسسين، مقابل تأكيده على دور العقلانية التواصلية بديلا عما يسميه العقلانية المنكفئة، وتشديده على ما يسميه بالتعلم المتبادل بين مختلف المختزنات الثقافية والرمزية للشعوب إلا أن هذه العقلانية التواصلية التي تحدث عنها ليست إلا عقلانية غربية مغلفة بادعاءات الصلاحية الكونية، وذلك سيرا على ذات المنوال الذي نحاه سلفه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر في مطابقة الحداثة في العقلانية، ومطابقة هذه الأخيرة في الميراث الثقافي اليوناني المسيحي على نحو ما جمعت خيوطه المتناثرة الإصلاحية البروتستانتية على ما يذكر فيبر في مواضع كثيرة من نصوصه، ولكن يبقى من المفهوم والمشروع أن ينافح هابرماس، ومن قبله ماكس فيبر أو أي مفكر غربي آخر عن عالمية الحداثة (أو عالمية نموذجهم) ولكن ليس أمرا مفهوما أن يدافع مثقفونا التنويريون عن نموذج أو نماذج حداثية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فلا هم من المساهمين في نحت معالمها ولا من المنتسبين إلى أهلها.
يتجاهل الخطاب بوعي، أو لقصور في الفهم والإدراك، يتجاهل عنصرين ملازمين لمفهوم الحداثة: أولهما أنه لا توجد حداثة بإطلاق بقدر ما توجد تجارب وأنماط معينة في الحداثة، وهذه الأنماط تختلف باختلاف المكتسبات الرمزية والتاريخية التي امتزجت وتفاعلت معها هذه الحداثة، وحسبنا أن نشير هنا إلى اختلاف تجارب الحداثة في السياقات الغربية من بلد إلى آخر، ففي الوقت الذى دخل الفرنسيون مثلا عالم الحداثة عبر ثورة عنيفة حاولت اقتلاع "العالم" القديم برموزه ومؤسساته الراسخة من القواعد، اختارت شعوب غربية أخرى سواء في العالم الأننجلوسكسوني مسارا أكثر هدوء ووفاقية سواء في التعامل مع موريثهم الثقافية والتاريخية، وفيما تعلق بعلاقة الديني بالسياسي، علما وأن تلك النمذجة النظرية للحداثة على نحو ما صاغها رجال الفكر والأكاديميا، والتي تقوم في الغالب على تاريخ انفصالي بين ماض غير حداثي وحاضر حداثي، هذه النمذجة لا علاقة لها بحركة التاريخ واقعا التي يتزاوج فيها الماضي مع الحاضر، ودليل ذلك أن الفرنسيين أنفسهم ورغم منزعهم الجذري الجامح ومسعاهم في القطع مع العهد القديم، إلا أن حادثة الثورة الفرنسية نفسها وعلى نحو ما بين ذلك ألكسيس دي توكفيل الذي يعد واحدا من أهم مؤرخي تلك الحقبة تبقى منغرسة ضمن وتيرة التاريخ السياسي والميراث الكاثوليكي الفرنسي نفسه، وتحمل من عوامل التواصل والاستمرار أكثر مما تدعيه من قطع وانفصال.
ثانيهما أن الحداثة في جانبها النظري ليست ماهية ثابتة منضبطة المعالم والشخوص بقدر ما هي صيرورة حية تحمل في ذاتها قابلية التدارك والتجاوز، وتنفتح على أفق الإمكان التاريخي والثقافي الرمزي، فالحداثة عوالم متنوعة ليست عالما واحدا وكليا، فكل تجربة في الحداثة تعكس الخزان اللغوي والتأويلي وأعماق الخبرة التاريخية التي انصهرت ضمنها، وإذا كان الفيلسوف الألماني هابرماس جادا في تعريفه للحداثة بأنها مشروع غير مكتمل وناجز فمن مقتضيات ذلك التخلي عن الادعاءات الشمولية للنموذج الليبرالي الرأسمالي وحسبانه واحدا من بين امكانيات أخرى، وليس الإمكان الوحيد.
خصلة رئيسية من خصال الحداثة هي القدرة على الابداع وطرق أسئلة غير مسبوقة ومنظورة، ومن ثم فإن الحداثي بحق هو من يمتلك القدرة على طرق أبواب جديدة، وتقديم تساؤلات وأجوبة غير مسبوقة وليس من يردد «مدونة الحداثة» وكأنها محفوظات مدرسية دون جهد في الابداع أو عناء في التفكير.
* باحث في الفكر السياسي والعلاقات الدولية ـ جامعة وستمنستر ـ لندن
جريدة الشرق الأوسط - الخميـس 06 محـرم 1425 هـ 26 فبراير 2004 العدد 9221، الإنترنت:
http://www.asharqalawsat.com/leader....article=219816













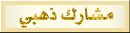



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

Bookmarks